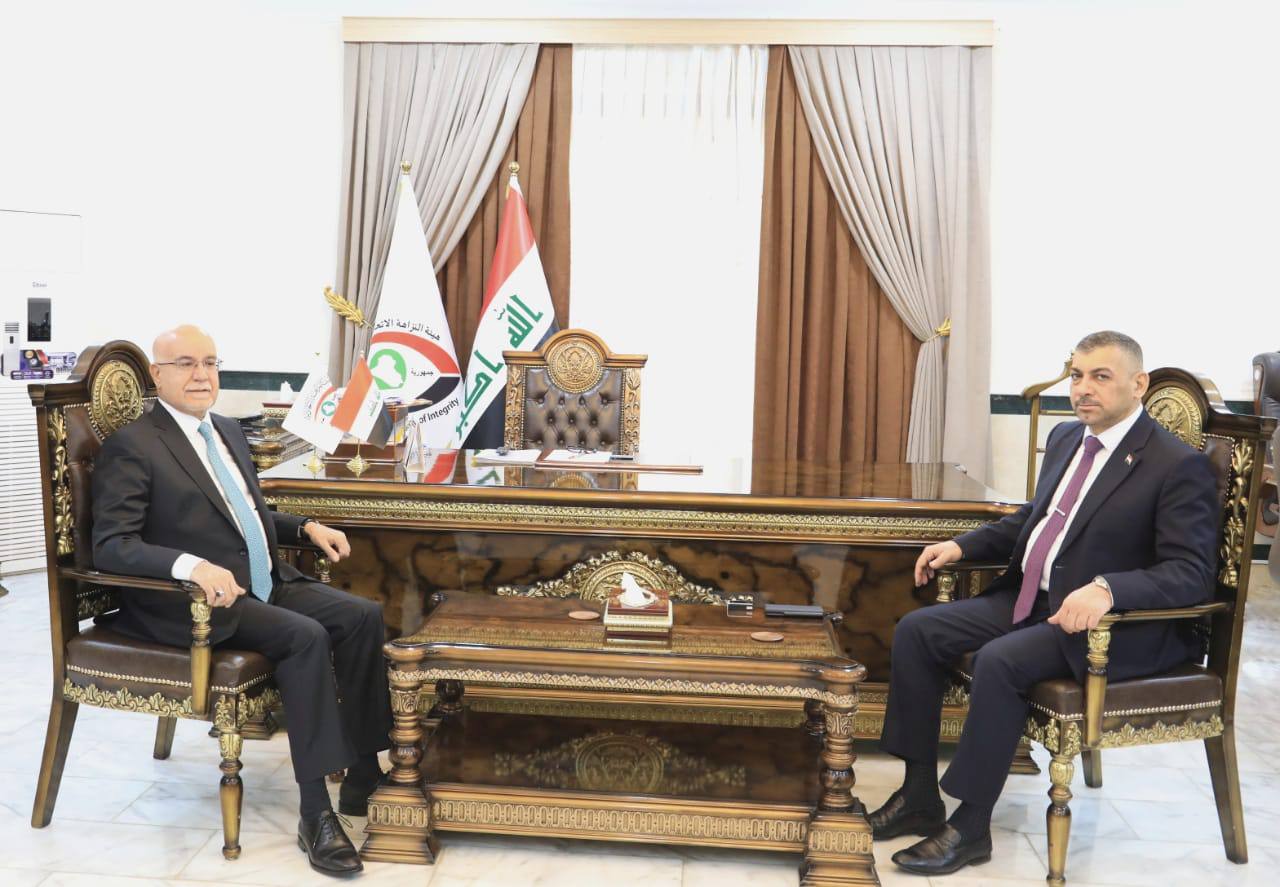27/07/2024
تعني النمذجة اختيار أنموذج يعتقد به المفكر العربي، ويعتمده بوصفه فكرا يحل مشكل النهضة، يُمكن أن نستعيره كم حضارة أخرى أو زمنا ثقافيا آخر، ونعمل على توظيف مقولاته في قراءة واقعنا العربي المعاصر. لنا أن نستحضر فكر زكي نجيب محمود، الذي عمل على استعارة الفلسفة الوضعية المنطقية، التي يظن أنها سبيل لتحقيق نهضتنا، فدافع عن مقولاتها في رفض الميتافيزيقا، وتبني الفلسفة العلمية بوصفها الحل لمشكل النهضة العربية.
ينتقد محمد عابد الجابري كل اتجاهات الفكر النهضوي العربي الحديث والمعاصر، لأنها اتجاهات تبني رؤيتها وفق تبني أنموذج تراثي أو حداثي، وهي في النتيجة «مرجعيات مستعارة» بتعبير د. عبدالله إبراهيم، لأن لكل منها سلفا تعود إليه، وهي تحسبه الأنموذج الأمثل لتحقيق النهضة.
لم يتفق المفكرون العرب المحدثون والمعاصرون في جل ما كتبوا، إلا على أن لكل منهم أنموذجه النهضوي، بل قل إنه «الخلاصي»، الذي حينما نستعيره يمكن لنا أن نحقق نهضتنا.
التراثيون حالهم كحال الحداثيين، فهم لهم أنموذجهم الذي يجدون فيه إمكانية تحقيق النهضة في حال تطبيقه، عبر العودة للماضي، لأن سبب تأخر المسلمين يكمن في عدم معرفتهم لأمور دينهم، ولم تكن لنا نهضة لولا وجود النهضة الرسالية المحمدية، التي تمكن فيها سيد الرسل من تحقيق أهدافه، لذا ينبغي علينا العود لما كان سببًا في نهضتنا الأولى أو «الماضي» الذي ننوء بحمله، ولا يكون لنا كون إلا بالتخلص من سطوة هذا النزعات الحداثية المرتبطة بالنزعة «الكولنيالية» الاستعمارية.
يذهب د. عبدالله إبراهيم إلى القول بضرورة نقد «المركزية»، وعلى الرغم من أنه يُركز نقده على نقد نزعة «التمركز الغربي»، لكنه في الوقت ذاته ينتقد نزعة «المطابقة مع الماضي»، ليؤكد ضرورة نقدها، بوصفها نزعة مهيمنة أسماها «التمركز الإسلامي» المقابل لـ «التمركز الغربي»، وكلاهما نزعتان اقصائيتان، كل واحدة منهما تؤكد «المطابقة» وتُهمش الفكر المختلف، بل وتُقصيه.
يؤكد محمد عابد الجابري في كتابه: «الخطاب العربي المعاصر» أن الفكر العربي، بل والنهضوي خطاب ينزع أصحابه إلى تبني نزعة سلفية، وإن اختلفت شكل هذه النزعة السلفية بين دعاة العودة للماضي «التراث» وبين دعاة تبني الحداثة، ولكن بالنتيجة جميعهم ينزع نزوعًا سلفيًا، ويرتكن إلى استعارة أنموذج جاهز من «التراث» أو من «الحداثة» ليُطبقه على حاضرنا، ويظن أنه أمسك بالحل!!.
تجد أن دعاة «التراث» يظنون أنهم هم القادرون على تحقيق النهضة لمجتمعنا، وفي المقابل لهم نجد «الحداثيين» يعتقدون هم من يُمسكون بالحل السحري لمشكل التخلف وتحقيق النهضة، وبين هذا وذاك مسافة النسيان للإنسان العربي، الذي لم يضعوه في الحُسبان، فهو ليس لعبة نُحركها حيثما نشاء ومتى ما نشاء، وقد لا تشغله فكرة التنظير لأولوية «التراث» أو «الحداثة»، لأن ما يشغله تحقيق الاستقرار.
لا أظن أننا نجد عند حداد أو نجار أو حرفي ماهر هذا المشكل في الأخذ من «التراث» أم من «الحداثة»، وقد تجد في ما يُبدعه عناصر مستقاة من «التراث» وأخرى من «الحداثة» ولا تجد في إبداعه نشاز تعترض عليه.
يبدو لي أن المشكل في توظيف «التراث» أو توظيف «الحداثة» يحضر عند «الدوغمائيين» أو العقائديين، وقل الأيديولوجيين الذين يُجيدون وضع العصا بالعجلة نتيجة هواجسهم المرضية ونزعاتهم «الراديكالية» في عدم قدرتهم على تصور إمكانية التواشج الحضاري بين ما هو «تراثي» وما هو حداثي» لأن «مسطرة» الأيديولوجيا هي الحاكمة عندهم في الحكم على فكر ما بأنه خطأ أو صح!.
كل ما قدمته «الحداثة» من آليات ومناهج يمكن لنا توظيفها في فهم «التراث» والإفادة منه وتوظيفه بما يجله حاضرًا بأبهى صورة، ولا أدل على ذلك من معطيات معاصرة لدينا في تحديث «شارع المتنبي» بآليات ومناهج حداثية أعادت له روح حضوره التراثي بما لا يخل بتصورنا «التراثي» عنه.
التداخل بين ما هو «تراثي» و ما هو «حداثي» صار أمرًا طبيعيًا، فقد تخدمنا «الحداثة» في إعادة بناء تصورنا للماضي الذي نعيش ذكرياته بما هو أجمل، ومن يُتقن إعادتنا لتذوقه، إنما هو الحرفي والمهندس الذي يعرف توظيف آليات «الحداثة» بما يخدم به تقديم «التراث» بصورة أبهى، والحال حصل ويحصل، ولا أدل على ذلك من إعادة بناء بيت شاعرنا «السياب» بآليات «الحداثة»، بروح لم يفتقد فيها بعده «التراثي».
مشكلة الصراع بين «التراث» و»الحداثة» يعيشها المفكرون «الدوغمائيون» في صراعتهم في التفضيل بين الأنموذجين، ولكنها عند الفنان والحرفي تحضر كلا النزعتين بلا صراع، بل باتساق و»تثاقف» أو «تلاقح ثقافي» طبيعي من دون هواجس وريبة المفكرين المتمترسين في عالم يعيشيون فيه لوحدهم ويُنّظرون له، ولكنه يسير بهم أو من دونهم.